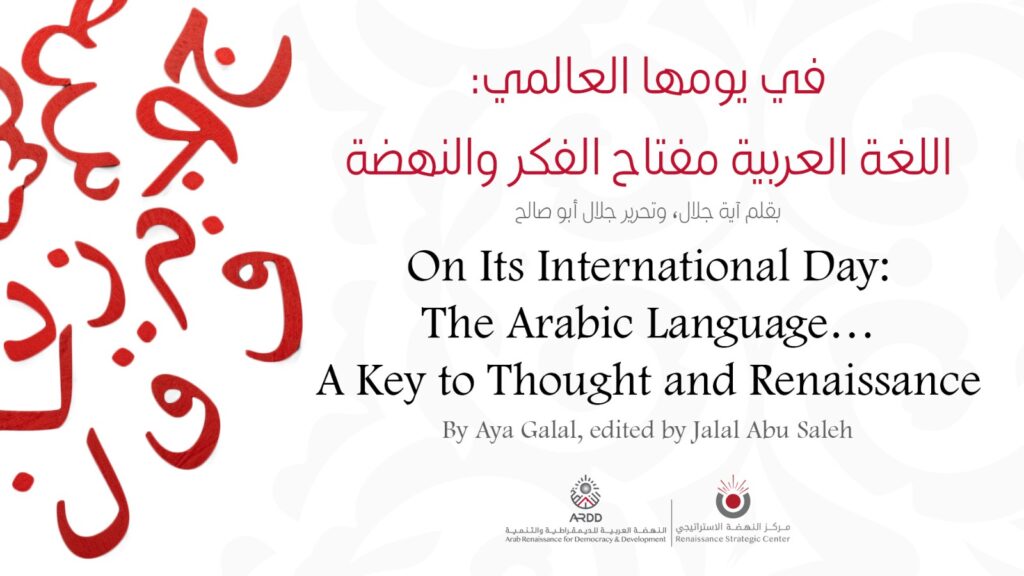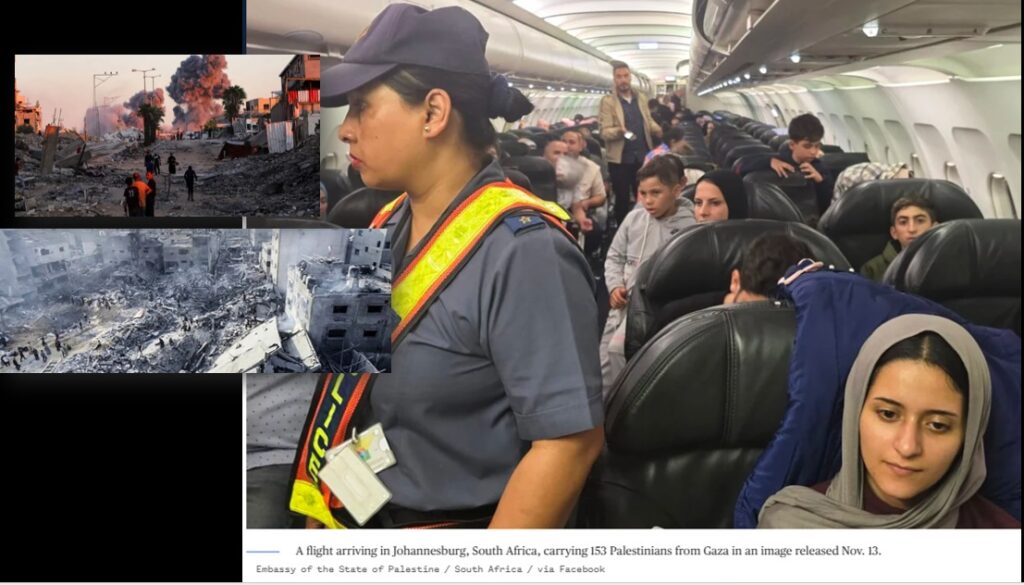يلاحظ المفكر السياسي الألماني الأمريكي “يوشع مونك” أن الديمقراطية في طور التراجع عالميُا، ولم يعد من الممكن الرهان على حركية تمددها وتوسعها على النطاق الدولي. في إفريقيا، تعود الانقلابات العسكرية إلى الواجهة وتعلّق الحياة السياسية التعددية، وفي أوروبا الشرقية، ترجع الأحزاب اليسارية الراديكالية إلى الحكم عن طريق الانتخابات، وفي قلب العالم الغربي تتزايد الديمقراطيات غير الليبرالية التي هي نمط من الأنظمة التسلطية التنافسية التي تنتهك دولة القانون ومسلك الفصل بين السلطات.
لقد أظهرت الأحداث الأخيرة بطلان “باراديغم” التنمية الذي يقوم على حتمية تحول المجتمعات الصناعية الليبرالية إلى النظام الديمقراطي، تثبيتًا للسلم الأهلي وضمانًا لحد أدنى من العدالة والشفافية وتكريسًا للوعي السياسي للأفراد.
في التسعينيات، كان التوقع سائدًا بأن الصين التي نجحت في مسار النمو الاقتصادي والصناعي ستتحول إلى الديمقراطية التعددية، فجاءت أحداث تيانانمن في بكين لتفنّد هذا التوقع.
لم يعد أحد اليوم يراهن على انتقال الصين إلى الديمقراطية الليبرالية، وبرزت دراسات رصينة تفسر خصوصية النموذج الحضاري الصيني وصلابته في مواجهة النموذج السياسي الغربي.
من أهم من تناول هذه الخصوصية الصينية الفيلسوف والمفكر الفرنسي “فرانسوا جوليان” الذي كتب عدة أعمال متميزة حول الفكر الصيني في جذوره النظرية والمجتمعية العميقة.
ما بينه “جوليان” هو أن الفكر الصيني يختلف في المحددات البنيوية عن المسار الغربي، بما يبرز في الفرق الجوهري بين نظرة للوجود تقوم على الجواهر والصور الثابتة كما تجلى مبكرًا في الفلسفة اليونانية، ونظرة تتأسس على الحركية والاختلاف والتغير المستمر، بما يتطلب في الثقافة الصينية فاعلية التكيف والتأقلم مع المستجدات الطارئة.
وفي حين يقوم الفكر الغربي في مقوماته المعرفية والمعيارية على البحث عن الكليات المجردة والقوانين الكونية، ينزع الفكر الصيني إلى نموذج التموجات الحركية والسيرورات المتدفقة دون انقطاع. في البناء المنهجي، ينتج عن هذه المقارنة اعتماد الغرب مسلك العقلانية البرهانية والمنطقية في مقابل النزعة الرمزية والإيحائية الصينية.
وإذا كان “هيغل” قد أشار إلى غياب بعد الذاتية في الفكر الشرقي (الصيني) رابطًا بين هذا البعد وفكرة الحرية والمقاييس الإنسانية، إلا أن الفكر الصيني اعتبر في بنيته العميقة أن الذات لا تنفصل عن الطبيعة والمجموعة، بل تتناغم معهما في انسجام مطلوب وضروري.
لا مكان في الثقافة الصينية للثورات السياسية والتغيرات الشعبية العارمة، بل ينظر إليها بصفتها تصدر عن مقاربة مثالية للسياسة كممارسة تطبيقية لأفكار مجردة، مفصولة عن الواقع الفعلي الملموس.
لا نجد في الثقافة الصينية المفاهيم المحورية التي يقوم عليها العقل السياسي الحديث في الغرب مثل فكرة السيادة الشعبية والتعاقد الاجتماعي والشرعية القانونية للدولة المدنية. الأساس بالنسبة للفكر السياسي الصيني هو حفظ الانسجام والتناسق والسلم في المجتمع، والعمل على التأقلم مع المتغيرات المتجددة التي تواجهه، وتوفير متطلبات الحياة الجماعية المشتركة دون حاجة للعنف المادي والتسلط الأحادي.
في أحد كتبه الأخيرة حول مفهوم “تيانكسيا” (الكل تحت السماء باللغة الصينية)، يبين الفيلسوف الصيني “زاوو تينغيانغ” أن الانزياح الواسع اليوم بين الغرب والصين ناتج عن خلفيتين متباينتين على المستوى الحضاري التاريخي: العالم المتعدد المتداخل والمتوازن (الصين)، والدولة من حيث هي مدينة بالمعنى اليوناني القديم (الغرب).
التيانكسيا تقوم على منطق الضيافة والانسجام والتعايش الاختلافي، وترتكز على ثلاثة مفاهيم مؤسسة هي: النظرة الداخلية للعالم من حيث هو نسق من الكيانات والأمم والثقافات المتعايشة ضمن نسيج وطني واحد، والعقلانية الترابطية التي تنزع إلى الحد من التصادم بدلًا من البحث الأقصى عن المنافع الحصرية، والتحسين المشترك الذي يتحرى الرفع الإيجابي من أوضاع الجميع لمصلحة المجتمع بكامله.
لا تتدخل التيانكسيا في المعايير المرجعية للعدالة والحقيقة، على عكس الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على الفصل بين الخير والعدل، لكنها تتناقض موضوعيًا مع اعتبارات هذا الفصل من خلال تصوراتها الضمنية التي تحول دون إبراز نموذج مكتمل للديمقراطية.
ما الذي يناسب المجتمعات العربية الراهنة؟ هل هو النموذج الليبرالي الغربي أو النموذج الصيني في مقاربته السياسية المجتمعية؟ هل تحتاج للحرية والحقوق السياسية أم النظام والفاعلية؟
منذ فترة قصيرة فقط، أصبحت الصين تروج لنموذجها الثقافي والسياسي، بعد أن كانت مغلقة على نفسها. في ستينيات القرن الماضي، اقترح بعض مفكري اليسار العربي مثل أنور عبد الملك وعادل حسين اعتماد النموذج التنموي والسياسي الصيني خيارًا بديلًا عن الغرب الليبرالي، لكن تلك الدعوة تمت في سياق التجارب الإصلاحية للماركسية الصينية في اتجاه تحرير السوق وتشجيع الإبداع والنجاعة ضمن ثوابت المجتمع الاشتراكي.
إلا أن أغلب المفكرين السياسيين العرب انساقوا في العقود الأخيرة إلى الترويج للمقاربة الليبرالية على الطريقة الغربية، رجوعًا لباراديغم التنمية، أي الترابط التلازمي بين اقتصاد السوق والديمقراطية التعددية.
بعد تعثر ديناميكية الربيع العربي، ظهرت تفسيرات لعجز التحول الديمقراطي العربي من منظور ثقافي مجتمعي، أي اعتبار عدم تناسب الديمقراطية الليبرالية مع الواقع العربي، من حيث طبيعة البناء السياسي (هشاشة الدولة الوطنية وضعف شرعيتها)، ونمط المنظومة الثقافية السائدة (غياب الفردية الذاتية وقيم التسامح والاختلاف)، في حين ركز البعض على العوامل الاستراتيجية الدولية (الموقع الجيوسياسي للعالم العربي وانعدام مظلة حاضنة له خارجيًا).
هكذا عاد النموذج الصيني إلى الواجهة، باعتباره الدليل الساطع على القدرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية الاجتماعية الناجعة والانسجام الداخلي والدولة القوية، وهي المتطلبات العاجلة والضرورية بالنسبة للعرب.
قد تكون الصين مختلفة جذريًا من حيث قيمها الثقافية عن العالم العربي، على عكس الغرب الذي يرجع لنفس المقومات العميقة والبعيدة التي تطبع الحضارة العربية الإسلامية، لكن تجربة التحديث الصيني تشكل دون شك حالة ناجحة وفريدة لا يمكن تجاهلها وإهمالها لدى سكان الجنوب الشامل الذي ينتمي إليه العالم العربي. من هذا المنظور يكون الدرس الصيني مفيدًا وثريًا للفكر النهضوي العربي.