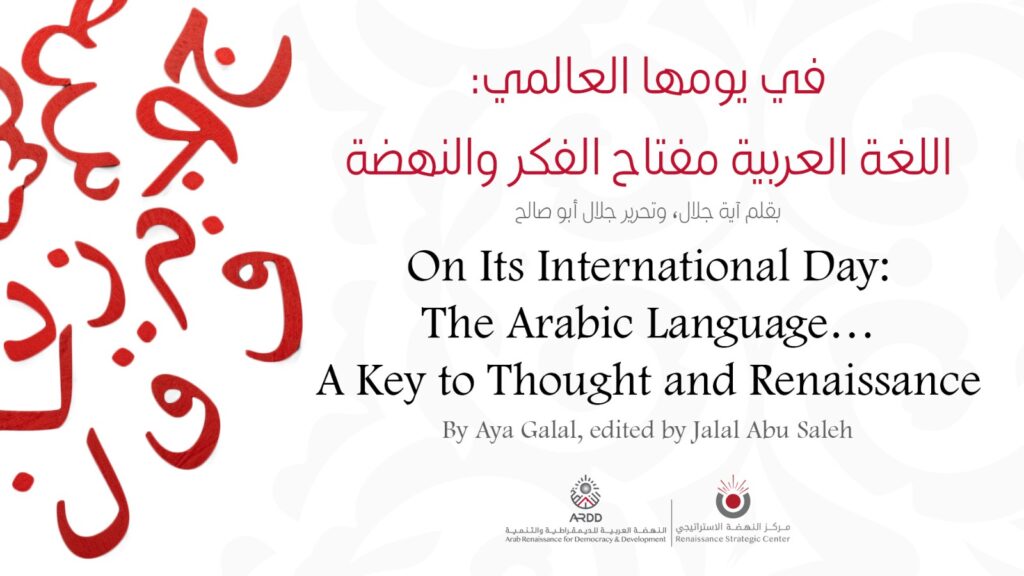عبارة “الليبرالية الوجودية” تعود للفيلسوف الكندي “هنري لفوفير”، الذي نشر مؤخرًا كتابًا هامًا بعنوان “الليبرالية طريقًا للحياة” (Liberalism as a Way of Life).
في هذا الكتاب، يرفض المؤلف الفكرة السائدة عن الليبرالية من حيث هي أيديولوجيا اقتصادية أو إطار مؤسسي للعمل السياسي والاجتماعي، معتبرًا أنها بالأساس طريقة حياة ونمط وجود يقوم على منظومة أخلاقية توجه الخيارات الكبرى في العيش ونمط العلاقة مع الآخرين.
في هذا السياق، يعدد “لفوفير” عدة محددات نظرية أساسية في الفكرة الليبرالية، من أهمها:
- مفهوم الاستقلالية الذي بلوره فلاسفة الأنوار، وبصفة خاصة “كانط”، وأناطوا به طبيعة الفرد الحديث من حيث هو كائن اجتماعي يتمتع بإرادة حرة وكرامة ذاتية، بما يؤهله للتحكم في مصيره وصناعة مستقبله دون وصاية من أحد.
- الهوية المفتوحة والمرنة مقابل التصورات الجامدة الجوهرية للذات التي تعيّن للفرد انتماءه الثابت قبليًا.
- محورية التسامح والاختلاف في مقابل الأفكار الأحادية والمذاهب الإقصائية المفروضة بالقوة والإكراه.
- منح الأولوية للعدل في دلالته الإجرائية مقابل تصورات الخير المشترك والفضيلة، احترامًا لمعايير ومقتضيات التعددية الفكرية والثقافية في مجتمع حرٍ ومتساوٍ.
ما يبينه المؤلف هو أن هذه القيم السائدة في المجتمعات الليبرالية لا تحمي في ذاتها من التسلطية والأحادية، إن لم تتحول إلى سلوك فردي ونظام عيش خاص، بحيث يكون الإنسان حريصًا في تصرفاته على احترام الآخر والتسامح مع آرائه ومعتقداته، وملتزمًا بأخلاقيات الإبداع والعمل والفاعلية التي هي أساس الممارسة الليبرالية العملية.
بطبيعة الأمر ليس هذا الخيار سهلًا، فالمسؤولية الليبرالية تضع الإنسان أمام إشكالية معقدة، تتمثل في صعوبة الخيار الفردي الحر ضمن خيارات متعارضة متباينة توفرها الحريات العمومية، كما أن غياب سقف معياري ملزم للفرد قبليًا يولد ضربًا من القلق والحسرة ليس من السهل التغلب عليهما.
لقد توقف الفلاسفة المعاصرون عند بعض جوانب هذه الإشكالية المحورية: كالهوة الدائمة بين الحرية الصورية المضمونة قانونيًا و الحرية العملية العينية، والانزياح بين الهوية الفردية ومقتضيات الانتماء لمجموعة عضوية، وطبيعة الحياد القيمي الممتنع بين التصورات القيمية المتصادمة اجتماعيًا.
لا يخفي المؤلف صعوبة هذه الليبرالية الوجودية التي يدعو إليها بما تقوم عليه من مسلكيات النقد الجذري والقلق المعرفي والمسؤولية العصية، لكنه يؤكد أن هذه المعايير السلوكية هي التي تضمن فاعلية واستمرارية الممارسة الليبرالية.
غني عن البيان، أن أطروحة “لفوفير” تعكس الأزمة العميقة التي تمر بها حاليًا المجتمعات الليبرالية في مناحٍ ثلاثة كبرى:
- أولًا: التضارب المتزايد بين المنظومة القانونية الضامنة لحقوق الإنسان والحريات العامة، وهي في عمومها فردية ذاتية، والعودة الاحتجاجية لمشاعر الهوية الجماعية، التي تأخذ في بعض الساحات شكل الدعوات العنصرية والأصولية الدينية والطائفية، وهي المخاطر التي قامت الفكرة الليبرالية أصلًا من أجل محاربتها ومواجهتها.
- ثانيًا: الانزياح العميق بين الحالة الليبرالية المعولمة التي أصبحت واقعًا لا يمكن الانفكاك منه، والحالة الليبرالية الداخلية المرتكزة على مبدأ السيادة الوطنية وحماية المصالح القومية، بما نلمسه بوضوح في سياسات عدد من الدول الكبرى التي كانت سابقًا هي الدافعة لحركية العولمة وها هي تسعى لكبحها راهنًا.
- ثالثًا: بروز الآثار السلبية لثنائية الوعي الفردي الحر الذي هو مجال القيم والفضائل من حيث هي أخلاقيات الضمير الفردي والوعي الجماعي المستند إلى توافقات قانونية إجرائية لم تعد اليوم كافية لضبط الأصناف الجديدة من التحديات المجتمعية التي لها أبعاد أخلاقية ووجودية معقدة وغير مسبوقة. لقد اعتبر الفيلسوف الألماني “يورغن هابرماس” أن الفكر الليبرالي مضطر اليوم للرجوع إلى مرجعيات ومنابع المعنى التي هي التقاليد الدينية والثقافية للأمم والمجتمعات بعد أن اعتقد انه أرسى قطيعة حاسمة معها منذ عدة قرون.
ما يثير قلق “لفوفير” ومعه آخرون هو أن الليبرالية اليوم قد ولدت من داخلها خطابًا وسلوكًا معاديين لها، بعد أن تغلبت فكريًا وعمليًا على الأيديولوجيا المناهضة لها تاريخيًا، أي الاشتراكية الشيوعية.
هذه الموجة العدائية الداخلية تبرز اليوم في ثلاث ظواهر شديدة الخطورة هي: النزعة القومية المتشددة التي تصدر عن هواجس الهوية الخالصة والانتماء “الصافي” بما يتعارض مع معيار الهوية المفتوحة والإرادة الفردية الحرة، والحماية الاقتصادية والانكفاء السياسي والاستراتيجي بما يتناقض مع مبدأ الكونية الإنسانية ومنطق التبادل الحر، والفصل بين الليبرالية كنظام اقتصادي وقانوني، والديمقراطية كنمط من التدبير السياسي.
الليبرالية الوجودية من هذا المنظور إذن تتجاوز المعطى السياسي والقانوني الضيق في الليبرالية، كما تتجاوز مكاسبها المؤسسية التي لا يشك أحد أنها مستقرة وصلبة في العالم الغربي. وهكذا، يستعيد المؤلف الأفكار الفلسفية الثرية التي واكبت نشأة و تطور الفكر الليبرالي. في هذا السياق، يمكن أن نستحضر مقولتين أساسيتين هما:
- مقولة “القلق الوجودي” التي ترجع إلى “كيركيغارد” و”هايدغر”، لكنها اشتهرت في كتابات “جان بول سارتر” التي ربطها بفكرة الحرية الإنسانية وما يتعلق بها من مسؤوليات جسيمة. صحيح أن هذه المقولة تراجعت كثيرًا في الخطاب الفلسفي في السنوات الأخيرة، لكنها تعود اليوم في أفق جديد هو أفق نضوب المعاني المؤسسة للتقليد الليبرالي الكلاسيكي.
- مقولة “أخلاقيات العيش المشترك” التي طمست في المدونة القانونية الليبرالية، وتجذر الاعتقاد العام بأن هذه المدونة قادرة على تعويض الفضائل السلوكية الفردية من منظور التمييز الشهير الذي اقترحه عالم الاجتماع “ماكس فيبر” بين أخلاق القناعة الفردية وأخلاق المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها القادة وصناع القرار . في العالم اليوم، وعي متزايد بضرورة العودة إلى فضائل وأخلاقيات السلوك الفردي الذي له آثار اجتماعية إيجابية، بعد أن تحولت الملفات السياسية الكبرى إلى القضاء العمومي وتراجعت نسبة ثقة الناس في رجال السياسة والحكم.
ما يريد أن يقوله “لفوفير” هو أن الليبرالية التقليدية القائمة على نظام اقتصاد السوق والتبادل الحر ومدونة حقوق الإنسان والفصل بين السلطات والديمقراطية التمثيلية، حتى لو كانت بديلًا مغريًا لشعوب العالم التي تحكمها أنظمة تسلطية قمعية، إلا أنها أصبحت تطرح داخل العالم الليبرالي نفسه إشكالات عصية تقتضي الانتقال من الليبرالية الأيديولوجية إلى الليبرالية الوجودية.